
ترشدنا المعاجم العربيّة إلى أنّ مادّة (قرأ) تدلّ إجمالًا على ضمّ شيء إلى شيء وجمعه، ثمّ يرصد المعجم الوسيط تطوّر دلالتها إلى تتبّع الكلمات بالنّظر مع النّطق بها أو بدونه. هذه الدّلالة تلتقي جزئيًّا مع الأدبيّات البيداغوجيّة؛ إذ تتضمّن القراءة بمعناها البيداغوجيّ السّاذَج عمليتين متتابعتين: فك التّشفير، فالفهم. وهاتان العمليتان متتابعتان إلا أنّهما غير متلازمتين بالضرورة؛ إذ يمكن للمتعلّم أن يقوم بعمليّة فكّ التّشفير إلا أنّه لا يتمكّن من فهم المقروء.
وقد اكتسبت “القراءة” بعدًا جديدًا في إطار مدارس ما بعد البنيويّة في النّقد الأدبيّ؛ إذ أصبح مفهوم القراءة دالًا على سيرورات العمل في “منطقة المخاتلة” بين الدالّ والمدلول سعيًا إلى تركيب أحجية المعنى، والكشف عن خبايا النّصوص الأدبيّة. ومن ثمّ أصبح تعدّد القراءات ملازمًا للنّص الإبداعيّ من ناحية، وطبيعيًّا بالنّظر إلى اختلاف منظورات القرّاء ومستوياتهم وأنواعهم من ناحية ثانية.
إنّ التّساؤل المطروح، من منظورٍ تداوليّ موسّع يتغيّا تسييق القراءة قياسًا على الظاهرة اللسانيّة – بما أنّ التداوليّات تعني ببساطة ” دراسة المعنى في التواصل، والألسن في الاستعمال- هو: لماذا نقرأ؟ وماذا نفعل حين نقرأ؟
يمكننا القول مطمئنين إنّ عمل العاقل لا يخلو من قصد وفائدة؛ ومن ثمّ فإنّ القراءة في حدّ ذاتها “فعل”؛ أي: سيرورة تحتوي على سبب وخطوات وغاية، ينطبق هذا على الطالب حين يقرأ متعلّمًا، والنّاقد حين يقرأ مستكشفًا وكاشفًا، والمهتمّ حين يقرأ مستمتعًا، وخالي الذّهن الذي يقرأ تزجية للوقت.
إنّ “الفعل”، من منظور تداوليّ موسّع، مُركّب يحتوي على ثلاثة وجوه متلازمة: مجرّد القيام بشيء، والقصد المتضمّن في القيام بهذا الشيء، ثمّ الأثر المترتّب على القيام به. ونعتقد أنّ قيام المُركّب ملازم لتمام أجزائه. وبناء على هذا؛ فإنّ فعل القراءة لا يمكن أن يكون على الوجه الذي نبتغيه دون وجهين يجري إهمالهما عادة هما القصد منه وأثره. ويترتّب على هذا أن نفكّر في هذين الوجهين في إطار السياقات الثقافيّة والاجتماعيّة التي نحياها في حياتنا المعاصرة.
يرتبط القصد المتضمّن في فعل القراءة عادة، وأوّل ما يرتبط، بالحاجة: الحاجة إلى المعرفة، أو الحاجة إلى المتعة الخيالية أو التخيليّة الخالصة، أو حتّى الحاجة إلى تمضية الوقت. ومن هنا ينبغي أن ندرك – وأن نعمل وفق ما ندرك- أنّ هذه الحاجات لم تعد تتحقّق بالقراءة وحدها؛ بل تعدّدت سبل إشباعها.
فكثيرًا ما يضيق الأساتذة ذرعًا بطلابهم، وكثيرًا ما يشتكون من عزوفهم عن القراءة، وكثيرًا ما نشكو من أنّ جماهير مباراة كرة القدم أضعاف أضعاف جماهير معارض الكتاب؛ لكن ما أقلّ ما نبذل من جهد على مستوى جعل القراءة بالنّسبة إلى هؤلاء الطلاب/ أو إلى الناس بوجه عامّ فعلًا محبَّبًا مشوّقًا، ومن ناحية ثانية على مستوى توسيع مفهومنا نحن لفعل القراءة ذاته.
ولنبدأ بالحديث عن ذلك المستوى الثاني، أي: توسيع مفهومنا لفعل القراءة؛ لأنّه تعلّة للأوّل.
ليس من شكٍّ أنّ وسائل المعرفة اليوم لم تعد كما كانت من قبل، في ظلّ عصر المعلوماتيّة والرّقمنة، بل عصر الصوت والصورة. وكلّ هذه الوسائل تمثّل تهديدًا للقراءة من منظور الرؤية التقليديّة الضيّقة. وهي بهذا المنظور تمثّل تهديدًا “لقراءة المطبوع” بلا شكّ، هذا ما أشار إليه طه حسين في أحد لقاءاته المتلفزة في أواخر حياته إذ أكّد أنّ دخول المذياع والتلفاز في حياتنا جعل الناس لا يقرأون، ولا يطيقون صبرا أن يقرأوا، ومن يقرأ منهم فإنّما يقرأ بعض الصحف السّيّارة بل بعض أبوابها فحسب.
أمّا إن وسّعنا مفهوم القراءة ومصاديقها في آن معًا؛ فالأمر مختلف. ماذا لو قلنا: إنّ القراءة هي فك شفرة يليه فهم لكلّ رسالة: مكتوبة أو منطوقة، صورة كانت أو فيلما أو حركة جسد أو إيماءة؟!
إنّنا بهذا نستوعب وسائل المعرفة المختلفة، ونرسل رسائل إيجابيّة ثمّ ينبغي علينا العمل الجادّ على تمكين الجماهير من امتلاك أدوات هذه القراءة الجديدة. وتتمثّل أدوات هذه القراءة الجديدة في مجموعة من المهارات البينيّة، ومهارات التفكير النّاقد، والتحليل التداوليّ للخطاب؛ حيث ينبغي أن يتعلّم الطلاب في المدارس منذ سني طفولتهم الأولى الرّبط بين مختلف المعارف التي يتلقونها بإيجاد التداخلات والتّشابهات، ثمّ المقارنة بينها للوقوف على الاختلافات. أمّا مهارات التّفكير النّاقد فمن شأنها تنمية شخصية الإنسان، وتدعيم استقلاليّته الفكريّة وقدرته على الاستدلال وإصدار الأحكام المنضبطة، كما أنّه ينمّي الكفاية التداوليّة من حيث دفع المفكّر إلى التقصّي والنظر في السّياقات المختلفة، وطرح الأسئلة الاستيضاحية للحكم واتخاذ القرار. أمّا التحليل التّداوليّ للخطاب فيساعد على كشف قصد المتكلّم، والرسائل المضمرة، وفهم السّياقات المنتجة للخطابات على مختلف أنواعها، وينمّي القدرة على الاستدلال والتحليل.
ولتحقيق هذه الكفايات لدى أجيالنا ينبغي أن تضطلع المؤسسات بأدوارها: فأنظمتنا التعليميّة ينبغي أن ترسّخ مهارات التعلّم من أجل الحياة التي تحوي، ضمن ما تحوي، ربط المواد التعليميّة المختلفة ببعضها بعضا، وتصميمها بناءً على المقاربة البينيّة التي تدمج الأهداف والسيرورات لتحقيق نتائج مبنية على أسس التفكير العلميّ الدقيق تسهم في حلّ قضايا معقّدة؛ إذ إنّ الأنظمة المعقّدة تستلزم بالضرورة منهجيّات مركّبة لحلّها. كما عليها أن تتخلّى عن الأفكار التقليديّة فيما يخصّ التقويم ونُظُمه والإجابات الأنموذجيّة وما يشبهها من أفكار عقيمة تعلي من شأن التقليد والتكرار والاجترار. وينبغي على مؤسساتنا التعليميّة والثقافية أن تعلي من شأن الإبداع والابتكار والتجديد؛ فتهتم بما أصبح مرذولًا في مجتمعاتنا؛ أقصد: الفلسفة والمنطق، والفنون بشتى أنواعها، كي تقوم بدورها في بناء إنسان متسائل، مفكّر، سويّ، يستطيع أن يتذوّق ويثمّن ويقيّم الفكريّ والمجرّد لا فقط الماديّ والمجسّد.
إذا استطعنا أن نوسّع مفهوم القراءة ومصاديقها؛ فإنّنا نستطيع أن نجعل فعل القراءة نمطًا حياتيًّا للجماهير. فالجمهور يمارس فعل القراءة حين يشاهد إعلانًا، وحين يشاهد فيلمًا، وحين يُعرض عليه خبر، ويكشف زيف ما تعجّ به وسائل التّواصل الاجتماعيّ من أكاذيب. وهو في الوقت نفسه إنسان متسائل مفكّر يطرح التساؤلات ويسعى للإجابة عنها، ولا شكّ أنّ الكتاب سيكون أحد المظان التي سيلجأ إليها، لكن: أيّ كتاب؟
تعدّ طرائق الكتابة والتأليف في عالمنا العربيّ من أعقد المشاكل وأشدّها تأثيرًا على إقبال النّاس على القراءة. فأدب الطفل والكتابات الموجهة إليه إمّا أن تكتب على أساس العُمر؛ فيأتي المضمون غير مناسب لمتعثرٍ يفوق هذا العمر لكنّه يعاني من تأخّر في مهارات القراءة، أو تُكتب على أساس المضمون فتكون صعوبتها غير مناسبة للمدى العمريّ المُستهدَف. وهنا ينبغي أن يقوم التأليف في جانبي العمر والمضمون على التدرّج في المستوى، أي: يتاح لكلّ عمر ولكلّ مضمون كتب متدرّجة من الأسهل إلى الأصعب بحيث يستطيع القارئ أن يحصل على ما يناسب عمره وقدراته الفكريّة واهتماماته في الوقت نفسه، وهذا متاح على سبيل المثال بكثرة كاثرة في اللغة الإنجليزيّة.
أمّا التأليف للكبار، إن على مستوى التأليف الإبداعي، أو الفكريّ، أو الأكاديميّ؛ فينبغي أن يدرك كاتبوه متغيّرات العصر، وتسارع وتيرته، ومن ثمّ يهتمون بالكيف لا الكم. ولعلّي أتذكر الآن أحد اللقاءات مع اللسانيّ والمفكّر الأمريكيّ الكبير نوام تشومسكي الذي أكّد أنّ الجيل الجديد لا يحب قراءة المراجع القديمة، ولا يطيق صبرًا أن يقرأ الفقرات الطويلة التي تمتد إلى صفحات متعدّدة، وقال إنّ ثقافة تويتر (إكس) ومنشوراته المحدودة بأربعين ومئة (140) حرفًا قد أثّرت على عقول هذا الجيل.
ونحن هنا أمام مفارقة: إمّا أن نكتب ونكتب ونحن على يقين أنّ أحدًا لن يقرأ، أو لن يطيق أن يقرأ هذا الكم، أو أن نعدّل طرائق الكتابة والتأليف كي تصلَ إلى القارئ، وتلاقي احتياجاته واهتماماته. فمن من النّاس الآن، مع أعباء الحياة الثقيلة، ومتطلباتها المتكاثرة، والبدائل الموجودة مسموعة ومرئية، يستطيع أن يواظب على قراءة كتاب كبير الحجم، أو موسوعة ضخمة متعددة المجلّدات؟!
ولا ريب أنّه يمكننا أن نقول: فمن شاء فليقرأ، ومن شاء فليُعرض، لكن يسقط بهذا القصد المُتضمّن في فعل الكتابة؛ إذ تصبح عبثًا لا طائل من ورائه، وتصبح صدًّا للقارئ بدل كونها تحفيزًا له. وهذا جزء ممّا قصدناه بأنّنا حين نوسّع مفهوم القراءة فنحن نرسل رسائل إيجابيّة، أي: بدل أن نتهمّ النّاس بالإعراض عن القراءة، علينا أن نخبرهم أنّهم في مناشط متعدّدة غير الإمساك بكتاب هم حقيقة يمارسون فعل القراءة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية حين نعدّل طرق التأليف والكتابة فإنّنا نشجعهم على الانخراط في فعل القراءة بالمعنى الأخصّ، أي: قراءة الكتب.
إنّ من وسائل هذا التّحفيز أيضًا أن يقوم على النّشر أناس لهم ذوق ومعرفة علميّة بأمزجة القراء؛ فيحسنون اختيار الكتب، ويحسنون إخراجها، ويساعدون المؤلفين في تزويدها بالأشكال التوضيحيّة، والصّور إن لزم الأمر، وغيرها من عوامل الجذب التي تؤهّل الكتاب كي ينافس مواقع الإنترنت، والبرامج الوثائقيّة المتلفزة، ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ؛ فتكون تزجية الوقت في قراءة كتاب متعة مماثلة وقادرة على المنافسة مع غيرها من وسائل تزجية الوقت. هذا إن كان القائمون على النّشر يرجون الرّبح، وهم يطلبوه بكلّ ما لديهم من قوة بلا شك لكنهم يخطئون طريقه، فيغالون في الأسعار نتيجة لقلة المبيعات؛ فينفضّ النّاس عنهم راغمين. وهذا يستلزم تعديل خططهم وطرقهم لجذب الجمهور وتحقيق ما يرجون من ربح.
ليس ثمّة طائلُ إذن من جلد الذات، واتّهام الجماهير بعدم الوعي، والعزوف عن القراءة، بل علينا، إن كنا حريصين على مستقبل هذه الأوطان، كلّ في موقعه، أن نحبّب إليهم القراءة، ونوفّر لهم أدواتها، ونسعى مخلصين إلى تقديم ما يناسب حاجاتهم واهتماماتهم. ولعّله من المناسب هنا أن نسترشد بالتجارب التي خاضتها بعض دور النّشر الكبرى في الغرب، وبعض دور النّشر الجامعيّ لجامعات عريقة، مثل: كَمبريدج وأكسفورد، حيث يعمدون إلى تقديم العلوم والاختصاصات المختلفة في كتيّبات مختصرة مكتوبة بطريقة تناسب القارئ العامّ لا المتخصص. وهذه خطوة مهمّة جدًّا نفتقدها في العالم العربيّ. وينطبق الأمر نفسه على الموسوعات الكبرى؛ فربّما يرغب القارئ العادي أن يأخذ فكرة عامّة عن موسوعة ما وما تتضمّنه من موضوعات، لكنّه في الوقت نفسه ليس براغب في استقصاء موضوعاتها جميعًا، بل قد لا يكون قادرًا من جهة المال والوقت أن يفعل ذلك. وهذا يمكن أن يكون مشروعًا وطنيًّا في كلّ دولة تحت شعار “المعارف العلميّة للجماهير”.
ختامًا، وبعد أن اقترحنا توسيع مفهومنا للقراءة ومصاديقها كذلك، ينبغي أن ننبه القارئ العزيز إلى أن الدماغ يشتغل بطريقة فاعلة عند قراءة الكتب؛ حيث تثير القراءة – حسب دراسات علميّة متخصصة – قدراته على التخيّل والتذكّر، والتّواصل الفعّال، وتنمّي الوصلات العصبيّة في المخ، وتحسّن وظائفه بصورة عامّة، كما تقيه من بعض أمراض اعتلال الذاكرة، وتحسّن الصحة النفسيّة للقارئ وتخفض معدلات الاكتئاب والتوتر. وهذا ما لا يمكن تحقيقه عبر مشاهدة التلفاز، أو تصفح الهواتف النقّالة وما يضارعها.
لقد أشارت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات البحثيّة الصحيّة أيضًا إلى خطورة مشاهدة التلفاز، أو الهاتف النقّال والأجهزة اللوحيّة على الأطفال، وتكون هذه الخطورة أشدّ ما تكون في السنتين الأوليين من عمر الطفل؛ إذ يمكن أن تسهم في إصابته بمتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه، وقد يصل الأمر وجود أثر لها في الإصابة بالتوحُّد. وبناء عليه أوصت بالأنشطة التفاعليّة والتواصليّة الحيّة مع الأطفال، ومنها قراءة القصص حتى في هذه السن الصغيرة. ونعتقد أنّ هذا له دور بارز في بناء عادات القراءة في المجتمعات، وخلق روابط بين الطفل والكتاب منذ نعومة أظفاره.
كاتب المقال: EduCareers
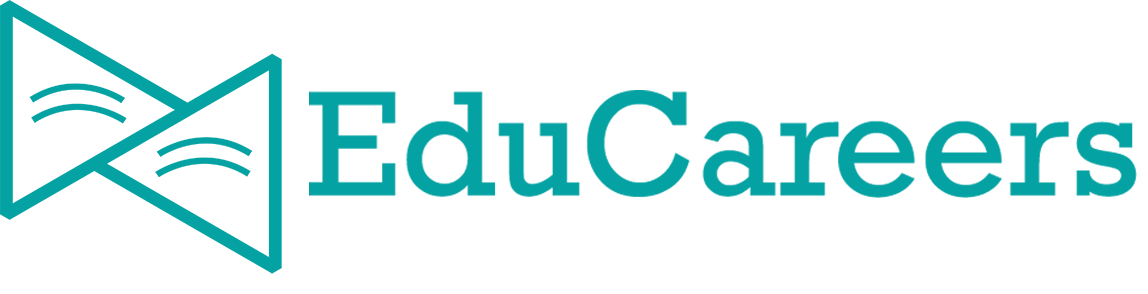



التعليقات (0)